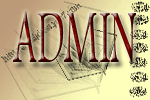عادت الفتاة الجامعية زينب عصام إلى بيت أهلها، بعد شهور قضتها متجولة بين الكنائس المصرية والأديرة وبيوت القسس والكهنة ، وللحق ، فإن ملاييناً من النفوس قد استراحت لهذه العودة لكنني (على ما يبدو) الوحيد الذي لم يسترح ولن يسترح لهذه العودة ، ذلك لأن الجانب الإعلامي والدعائي أوقع نفسه كما أوقع المجتمع الإسلامي في شراك الانبهار بعودة زينب كرد فعل لحادث ذهابها إلى المجهول منذ شهور طويلة ، واستدعاءً للذاكرة المصرية فقد كان الإعلان عن حادث تنصير زينب هو في ذاته رد فعل من الزميل مصطفي بكري للتهدئة من رَوع المسيحيين الغاضبين لإسلام وفاء قسطنطين ، والمعتصمين في فناء مقر رئاسة الجمهورية الأرثوذكسية المستقلة في منطقة العباسية بالقاهرة ، فنزل المقال برداً وسلاماً على قلوب المسيحيين المصريين الذين أعلنوا في لافتاتهم وهتافاتهم التي تناقلتها وكالات الإعلام والفضائيات المحلية والدولية أن قلوب المسيحيين تلتهب بالنيران ، ولا نجد حرجاً من القول بأن هذا المقال (مقال مصطفي) كان واحداً من الأسباب المهمة في تهدئة الهياج الإعلامي في الكنيسة المصرية ، بحسب مفهوم أولاد البلد عندما يقولون في لعبة (الكوتشينة): (بصره) ، أيّ واحدة بواحدة ، أنتم يا مسلمون أخذتم وفاء ونحن أخذنا زينب . والحقيقة أن المسلمون لم يأخذوا وفاء ، ولكن المسيحيين هم الذين خطفوا زينب المسلمة وسرقوا وفاء زوجة قس البحيرة ومريام زوجة قس الأميرية وطبيبتي الفيوم دفعة واحدة ، لذلك كان مقال مصطفي بكري في الوقت نفسه ، ضربة قاسية وعنيفة على رأس المسلمين في مصر والعالم كله ، وإن لم يقصد إلى ذلك ولم يتبادر إلى ذهنه . لقد كان مقال بكري بصقه وصفعة على وجه المسلمين ، ولكمة أسقطتهم أرضاً ، إذ كانوا من قبل في حالة ترنح شديدة ، ومهيئين كل التهيئة لهذا السقوط والانبطاح ، تماماً كما أرادت لهم أجهزة الشرطة خلال السنوات القليلة الماضية ، إذ رسَّخت في نفوس المسلمين كل المشاعر المؤلمة من الضعف والخوف والمهانة والخذلان تحت مظلة مقاومة الإرهابيين الذين باتوا خبراً ماضياً ، لكن آليات المقاومة لما عز عليها وجود إرهابيين جدد أبت أن تتوقف وواصلت العمل في شباب المسلمين بكل طاقاتها ، فتصنع منهم إرهابيين ثم تفرج عن بعضهم وتبقي بعضهم في متوالية عددية أمنية رتيبة ودقيقة ، لن تتوقف على ما يبدو إلا أن يجربها كل شاب مسلم أصيب مرة ولو على سبيل الخطأ بفيروس ارتياد المساجد أو الصلاة في جماعة وخاصة صلاة الفجر التي تحرك سيارات الشرطة أوتوماتيكياً للوقوف بظهرها أما أبواب المساجد لجمعهم في بطنها المتوحشة التي لا نراها إلا في حالة حمل سفاح دائم ، ثم إسقاطهم على أبواب إدارات أمن الدولة . ولأن الشباب المسلم لا يملك أي مضادات حيوية لهذا الفيروس (بحسب الرؤى الأمنية والعلمانية) الإلهي ، ولا يستطيع مقاومة الإصابة به باعتبار ذلك قدراً ربانياً ، فلن تتوقف آليات الشرطة عن مقاومة الإرهاب إلا أن يقضي الله أمراً كأن تعود الدولة إلى الله ، أو يعود رؤساء المؤسسات الدينية إلى رشدهم ويعترفون بحقوق هؤلاء الشباب عليهم ، وقدرهم عند ربهم . ونعود سريعاً إلى وفاء قسطنطين ونقول أنها كانت واحدة من عشرات أخريات يتحولن يومياً إلى الإسلام في السر وفي العلانية ، لكن دنيا الكنيسة قامت لها فجأة ولم تقعد دون كل الذين يسلمون صبيحة كل يوم ؛ مظاهرات ، هتافات، لافتات، سيارات ، حجارة ، جنوح ، تطرف ، إرهاب ، وشتم ، سب ، احتجاز صحفيين ، إهانة سياسيين ، بيانات ، تصريحات ، فضائيات ، انترنت ، صحافة ، نشرات ، منشورات . كل ذلك حدث داخل المقر الرئيسي لجمهورية الأرثوذكس بالعباسية ، ووقفت الشرطة حياله موقفاً سلبياً لم نعهده منها في تاريخها المعاصر كله ، وكان عجيباً كالخيال ، مخيفاً كالكابوس ، ونحن نرى ضباط الشرطة واقفون مستسلمون في أدب شديد ، يسمعون السباب برحابة صدر ، ويقرؤون لافتات استدعاء بوش وطلب النجدة من شارون بروح رياضية ، ويتلقون الحجارة على رؤوسهم برباطة جأش ، ويجمعون ضحاياهم من الضباط والعسكر بالتسليم والرضا الكاملين. ولعلي أعذر الشرطة كثيراً في هذا الموقف السلبي المبالغ فيه ، إذ كان من الخطأ الفاحش أن يواجهوا غضب شعب الجمهورية الأرثوذكسية الذين يطالبون بعودة وفاء إلى المسيحية ، بالأساليب نفسها التي يواجهون بها المجرمون المسلمون الذين يطالبون بتطبيق شرع الله فيهم وعليهم ، وكان من الشطط الأمني أن تتخذ الشرطة موقفاً غير الذي وقفته ، لأن غجر المهجر في أمريكا وكندا وأوربا واستراليا كانوا يتمنون لو تجرح الشرطة كلباً من كلاب الكنيسة ، فما بالكم لو أن جرحاً أصاب متظاهراً أو كاهناً من الذين تركوا الرهبنة والتبتل والزهد والجوع في براري الأديرة والصوامع ، وجاءوا لنصرة إخوانهم في قلعة الجمهورية الأرثوذكسية بالعباسية ، وشد أزرهم في مواجهة جمهورية مصر العربية المعتدية عليهم ، إذ لو حدث أن كلباً كان قد أصابه جرح في فناء الكنيسة أو خنزيراً في حظيرتها ، لقامت الدنيا في العالم الصليبي كله متحدثة عن إرهاب حسني مبارك الذي قاد بنفسه حملة تطهير عرقية للقضاء على المسيحيين في مصر كلها ، ولا يتعجبن أحداً من هذا القول ، ولا يحسبني ساذج أنني أبالغ فيه ، إذ أن غجر المهجر قالوه بالفعل لكن بأسلوب أكثر فجاجة ، وبعبارات دنية وقحة خسيسة، في حق مبارك ووزير الداخلية معاً. ولا يعني هذا القول تبرئة الشرطة من هذا الموقف المشين الذي فضح ضعفها ومهانتها في معالجة الحدث ، لأن سؤالات مهمة طرحها الناس في الشارع المصري على قادة وزارة الداخلية : ـ ما الذي أوقع الشرطة في هذا المأزق ؟ ـ ولماذا تستأسد على المسلمين ولديها إمكانية أن تكون حملاً وديعاً كما كانت مع شباب البابا شنودة ؟ ـ ولماذا كان شباب الكنيسة (الإرهابيين المجرمين المارقين المؤججين للفتنة المعلنين كفرهم بمصر وطناً وشعباً وتاريخاً) محل اهتمام كبيرهم الديني ، في الوقت الذي كانت فيه مهمة كبراء المسلمين قاصرة على بذل الجهد في إعادة وفاء قسطنطين للكفر . لكن على العموم ، فقد انتهى الحدث وسقط من الذاكرة قبل أن تأتي الإجابة ، وما يسقط من الذاكرة لا بأس من إهماله كلية في أزمنة الطوارئ والمبادئ المتغيرة تبعاً للظروف ، باستثناء علامة الاستفهام الغائبة التي تدور حيث ندور ، تطاردنا أينما نكون : ــ لماذا حدث كل ذلك عند إسلام وفاء قسطنطين وميري عبد الله ولم يحدث من قبل عندما أسلم المهندس سمير ابن شقيقة البابا شنودة ، وعندما أسلمت الحاجة إجلال قريبته ، وعندما أسلمت شقيقة الأسقف بيشوي (الذراع الأيمن للبابا شنودة) ، وعندما أسلمت ابنة أحد الصحفيين المسيحيين أصحاب الشهرة العريقة في عدائه للإسلام بمجلة روز اليوسف ؟ كما تحتوي ملفات الذين أسلموا ، أسماء العشرات بل المئات (دون مبالغة) لأبناء وبنات من الأسر المسيحية العريقة ، ومن القسس والكهنة وكبار رجال الكنيسة وزوجاتهم وبناتهم وشقيقاتهم وأكثر من ذلك ، وقريب من أيدينا ملفاً ضخماً يحتوى على أكثر من ألف شهادة إشهار إسلام ، ورغم كل ذلك لم تقم مظاهرة واحدة ، ولم يجتمع شباب وفتيات وكهنة وقسس الكنيسة من كل فج عميق ليفضحوا عن حقيقة مشاعرهم العدائية تجاه عوام المسلمين وتجاه مصر كلها ، وقد أعلنوا بكل فجاجة أنهم باسم الرب يسوع على استعداد لحرق مصر كلها وأهلها في سبيل وفاء قسطنطين ، وطالبوا بدعم البروتستانتي الصهيوني جورج بوش ، واستجدوا حكم الفاشي النازي المتوحش شارون ، ليذلا المسلمين في مصر ، ويشفيا الغل الذي يملأ صدورهم كما ملأ صدر الراحل أنطون سيدهم من قبل وعبر عنه جهرة في مقالاته بصحيفة وطني العنصرية الصهيومسيحية ، فسقطت بذلك كله وغيره كثير ، أسطورة محبة يسوع الكاذبة ، وافتضحت سوءة الوداعة الكنسية المخادعة ، ورأينا الحمل الوديع كبشاً ينطح ويكسر ويدمر ويحرق . ومن خيبة بعض المسلمين (كعادتهم على مدى التاريخ) أن الجاني لم يلتمس منهم لنفسه العفو ، ولم يعتذر لهم عن أفعاله الوقحة الدنيئة الخسيسة ، ولم يصرح ولو من باب المجاملة عن رغبته في وصف هذه الهمجية الكنسية بالحالة المفاجئة أو المشاعر الطارئة ، بينما نجد من المسلمين من تلمس الشفاعة للجاني المجرم ، وبحث له عن مبرر لجنايته ، وهيأ له من الأعذار ما جعله ضحية لا جاني ، ومقهور لا باغي ، ومستسلم لا معتدي ، بل ولا بأس أن تتطور هذه الرؤى الظالمة من بعض المسلمين ، لتحمل مضموناً أكثر إيجابية للطرف المسيحي ، فتوجه الاتهام إلى المسلمين بأنهم السبب في هياج مشاعر المسيحيين ، لأنهم يجهرون بصلواتهم ، وصيامهم ، وحجهم ، ويتمشون في الشوارع مستغفرين ربهم ، ويطالبون حكامهم بتطبيق شرع الله فيهم . ولا بأس أبداً أن تقرأ وتسمع وتشاهد واحداً من المسلمين وهو يطيب خاطرك ، ويطلب منك إغلاق المساجد باعتبارها بؤر للإرهاب ، وتعطيل مكبرات الصوت التي تزعج الناس عند كل أذان ، لأنها ليست في رقة أجراس الكنيسة ذات الأنغام المتنوعة ، فالأذان يؤرق بينما الأجراس تطرب ، وخطباء المساجد صوتهم جهوري ، بينما القسس في جوف الكنائس لا نسمع لهم صوتاً ، وإن سمعناه فهو تراتيل كالشدو وإنشاد بالموسيقى والألحان ، وهو في الحقيقة فحيح الثعابين.  ثم نعود إلى زينب ، ونقول أن خبر تنصيرها كان طعنة في ظهر المسلمين ، ليس لأن فتاة تنصرت ، فهذا أمر لا نجد فيه حرجاً للمسلمين في ظل الانتكاسة المزمنة لوزارتي الأزهر والأوقاف وتحولها إلى ألعوبة في يد أجهزة الأمن ، ولكن لأن الخبر جاء لإرضاء إرهاب الكنيسة ، ولتهدئة شبابها ، ولتفادي جنوحهم ، ولإطفاء ثورتهم ، فكانت لهم عودة وفاء ، وكانت لهم سرقة زينب ، أما المسلمين فكانت لهم صاعقة وقائع عودة وفاء تحت سطوة القوة والعنف والإرهاب ، وأخذلتهم سلبيتهم ، وقلة حيلتهم ، وهوانهم على حكومتهم وعلى أنفسهم ، وسوء صمتهم ، وهم يقرؤون خبر سرقة واحدة من بناتهم ، فكانت الحسرة حسرتان ، والمصيبة مصيبتان ، والكبيرة كبيرتان ، دون أن يعترض واحد منهم كبيراً أو صغيراً ، وقد ألجمهم الخوف والرعب من الشرطة التي طالما استأسدت عليهم وعلى آبائهم وأمهاتهم وأعراضهم ، فأورثتهم الخزي ، وأصبح الهوان من مكونات شخصياتهم ، فلم يجدوا مخرجاً إلا أن يكونوا أحد ثلاثة : ــ أناس صامتون مستسلمون لا جمل لهم ولا ناقة فيما يدور حولهم أو يتعلق بشأن دينهم . ــ أو أناس قد منحوا أنفسهم وظيفة عسكري أمن الدولة في رقابة المجتمع الذي يحوطهم ، فينصحون ذلك بمنع ابنه من ارتياد المسجد ، وينصحون هذا بمنع ابنه من إطلاق لحيته ، وينصحون ذلك بمنع ابنته من ارتداء النقاب ، ويرتفع صوتهم دفاعاً عن الوحدة الوطنية إذا ما ذكر عالم أو داعية آية قرآنية تتعلق بكفر من يقول بصلب المسيح عليه السلام ، أو درس علم حول نفي إلوهيته . ــ أما الصنف الثالث فقد ارتمى في حضن وزارة الداخلية استجابة لعروضها السخية ، فأصبح مألوفاً أن نجد في كل مجلس إدارة مسجد أو جمعية خيرية أو مجلس نقابة أو أعضاء هيئة تدريس أو اتحاد أهلي أو منظمة مدنية ، واحد أو اثنين أو ثلاثة يفخرون بعلاقتهم بمحمد باشا ، وبمصطفي بك ، وبمعالي على بيه الضباط بوزارة الداخلية . حتى فضلاء الشيوخ والعلماء والدعاة وأصحاب القلم وأنا واحد منهم ، لا يملك واحد منا أن يدعو أو يعمل في سبيل الله ، إلا بإذن سابق منهم ، فأصبح المسلمون جميعاً بلا استثناء ، ابتداءً من شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتى الديار ، وانتهاءً بالشيخ فلان والشيخ علان وأبو إسلام ، لا نستطيع دخول بيت الخلاء إلا بإذن سبق ، والحصول على موافقتهم باعتبارهم أرباب البلاد ونحن أولاد الـ ... ـلاب . والنتيجة التي ارتاحت إليها السلطة الحاكمة ، وباركها فضيلة الإمام الأكبر ، واستراح لها فضيلة مفتي الديار ، ورضي بها فضيلة وزير الأوقاف ، وغض الطرف عنها فضيلة رئيس أكبر مؤسسة دينية في العالم الإسلامي وهي جامعة الأزهر ، وهي عودة وفاء قسطنطين مرتدة عن الإسلام برغبتها أو غصباً عنها ، ولو لم تفعل ذلك ما عاد البابا شنودة لشعبه ، فقد راهن شنودة العالم كله على إرضاخ السلطة المصرية له ، ورهن ممارسة سلطاته لرئاسة الجمهورية الأرثوذكسية بتسليم وفاء له . أما شيوخنا رحمة الله عليهم ، فقد قاموا بكل ما أملته عليهم شريعة الوحدة الوطنية من مناسك وطقوس ، فأقنعوا وفاء بالردة ، وباركوا لزينب كفرها بالإسلام ، وكان بعض (المخابيل) من المسلمين قد ظنوا سوءاً وتبجحاً أن قادة المؤسسات الدينية في مصر سوف تكون لهم غضبة من أجل زينب مثل تلك التي غضبها البابا شنودة من أجل وفاء ، فيطالبون الدولة بإعادة زينب أو يعتكفون في مسجد عمرو بن العاص . بينما تصور بعض السذج من المسلمين أن البابا شنودة سوف يرد الجميل للرئيس مبارك الذي أعاد له وفاء ، فيعيد له زينب ، لكن شنودة لم يفعل ولن يفعل في يوم من الأيام ، لأنه صاحب مبادئ لا يتزحزح عنها حتى لو زحزحوه عن رئاسة جمهوريته الأرثوذكسية ، وعلى رأس هذه المبادئ الحفاظ على أبنائه من خطر التوحيد ، والسعي الحثيث على هداية المسلمين إلى عقيدة المسيح الإله الخروف (حسبما يعتقدون) ، فتعود وفاء إلى حظيرة يسوع ، ولا تعود زينب إلى حظيرة الكفر المسماة بالإسلام . وصاح الديك صيحته التي أنامت القوم جميعاً ، ولم تستيقظ شهرزاد من نومها ، مستمتعة بالغفلة والسُبات العميق والغطيط ، فلم تيقظها بعد ذلك عودة طبيبتيّ الفيوم من الإسلام إلى المسيحية ، ولم تؤرق نومه تحول خلود ودعاء ونادية وفاطمة من الإسلام إلى المسيحية من بعد زينب . لكن الله شاء ــ ولا راد لمشيئته ــ أن تعود خلود إبنة الموظف الصغير ، وأن تعود دعاء بنت المدرس الملتحي ، وأن تعود نادية بنت المحامي الكبير ، وأن تعود فاطمة ابنة طبيب القلب اللامع ، كل هؤلاء وعشرات غيرهم ممن جاءت إلينا أخبار تنصيرهم قد عادوا إلى عقيدة التوحيد بعد أن أغراهم الكفار بكفرهم والمشركين بشركهم ، ثم من بعدهم عادت زينب على غير وقع أو سابق خبر ، وهو الحدث الذي هز جدران الكنيسة المصرية من داخلها ، كما اهتز له وجدان المسلمين الذين علموا بالخبر ، ومرت الأيام ثقيلة وغير مريحة بداية من رحلة عودة زينب من المسيحية إلى الإسلام تحمل الكثير من الأسرار غير المعلنة ، والقليل من الأخبار التي تسربت بغير قصد أو قصد إلى وسائل الإعلام ، ومن بين الذي لم يتسرب هو استضافتنا لزينب في حضور أحد القسس الذين كانت تختفي زينب في بيوتهم ، وقد ألبسناها النقاب وجلست بين العديد من الأخوات اللائي جئن للترحيب بها ، والتعبير لها عن سعادتهم بعودتها إلى الحق . وفي هذا اللقاء الذي حضره جمع من الشباب الذي تلهف طويلاً للاطمئنان على أختهم التي تاهت منهم وضلت الطريق لأكثر من ثلاثة أعوام دون أن تجد من يأخذ بيدها أو ينتشلها ، واعتلت وجوههم ووجوههن علامات عديدة من الفرح والأسف والأسى والحمد والحزن والضيق والسرور واللوم ..... والكراهية ، بسبب ما حدث لزينب أو أحدثته هي لهم وفيهم . وفي هذا اللقاء أجريت بالصوت والصورة حواراً طويلاً مع زينب لأكثر من ساعة ، أباحت بما أرادت وأخفت ما أرادت ، ندمت على ما رغبت هي الندم عليه ، ولم تندم على ما تمنى الحضور أن تندم عليه ، عَذرَها البعض ولم يعذرها البعض الآخر ، تلمّس خطئها البعض ولم يتلمسه البعض الآخر ، إلى أن أفشى الزميل الصحفي فراج إسماعيل بموقع قناة العربية ، أسرار حوارنا الشخصي حولها ، وجعله كله مادة صحفية ، ففرحت لذلك كثيراً بقدر أسفي كثيراً ، ورحبت به بقدر رفضي له ، ذلك لأنني أملك يقيناً إيمانياً يريحني كثيراً في حياتي ، أن كل شيء هو بقدر الله ، النشر بيده سبحانه وتعالى ، وعدم النشر بيده سبحانه وتعالى ، الستر على الأسرار أو البوح بها خاضع لمشيئته ، وما نراه شراً قد يكون فيه الخير الكثير ، وما نتصوره خيراً قد لا يكون فيه إلا ما هو شر . لذلك غضب الإخوة الذين واظبوا على دعوة زينب إلى الله والسعي لإعادة توازنها إلى درجة محاولة إفشال مشروعي الوليد الأكاديمية الإسلامية لدراسات الأديان والمذاهب ، إذ كان منهم أربعة يتعاملون مع زينب فامتنعوا عن حضور المحاضرات المكلفون بها ، وغضبت زينب عبد اللاه الصحفية بالأسبوع لأن فراج إسماعيل سبقها في النشر فلم تنشر كلمة واحدة عن الأكاديمية ، وغضبت زينب عصام صاحبة المشكلة لأن فراج إسماعيل كتب معلومات تجرحها رغم أن ما كتبه فراج فيما أغضب زينب كان قد استقاه من مقال سابق لمصطفي بكري عن اتصال بعض الشباب المسيحي بها في المنزل قبل تنصيرها . لكن المهم والخلاصة ؛ أن زينب عادت إلى حضن أبيها وأمها وأخوتها ، مسيحية شديدة البأس ، ثم تائبة إلى الله تؤدي الصلوات الخمس ، وتغطى بعض ما كانت في المسيحية قد كشفته من أعضاء جسدها ، وتقرأ القرآن ، وتبكي عند سماع الدعاء ، بغض النظر عن التفاصيل التي نرجئها لأسباب لا يهم كثيراً الانشغال بها الآن ، وعلى رأسها أنها لم تكن يوماً قديسة صاحبة معجزات ، ولا كانت داعية شديدة المراس ، إنما كانت واحدة مثل آلاف الفتيات الذين في مثل عمرها ونراهم في بيوتنا وبيوت جيراننا وفي الشوارع والمحال والمدارس والجامعات ، وقد تظل على ذلك النهج طوال حياتها ، وقد يشاء لها الله ـ إن هي أرادت ـ أن تكون واحدة من أشهر وأذكى الداعيات إلى الله ، وليس ذلك على الله ببعيد ، فمن قبلها عادت (خلود) بجهد الدكتور (ع) ، وعادت (دعاء) معي بعد قصة مؤلمة مع أهلها ، وعادت (نادية) بعد قصة جميلة أفادتني كثيراً بصراحتها المطلقة ووعيها الكبير وما نقلته إلينا من معلومات عن أسماء المنصرين وأماكنهم وهواتفهم والوسيلة العفنة التي استخدموها في تنصيرها ، وكان أهلها على قدر كبير من التعاون والتفاهم والاحترام ، وكان أيضاً فضل الله علينا كبير في حالة ابنتنا (رشا) بكلية الخدمة الاجتماعية في حلوان ، والتي ألحدت وكفرت بالإسلام وبكل ديانة أخرى ، بتأثير بعض أساتذتها وعدد ليس بالقليل من زملائها وزميلاتها ، إذ أصاب الرعب والخوف والدها صاحب الوجاهة الاجتماعية فاكتفى بعلاج حالة ابنته ، وعودتها إلى اتزانها الديني ، وقراءة القرآن والصلاة المنتظمة بل والصوم يومي الاثنين والخميس ، لكنه رفض رفضاً شديداً أن تدلني ابنته على زميلاتها وزملائها الذين تحولوا من الإسلام إلى الإلحاد ، وكان لشقيقتها الكبرى بنفس الجامعة الدور الكبير بما أولته لها من حب وعناية واهتمام ومودة فجزاها الله الخير الوفير ، أما فاطمة الزهراء فقد كانت عودتها بفضل الله وعونه بعد صراع طويل مع أحد أعوان البابا شنودة ، انتكاسة لواحدة من أكبر الكنائس الأرثوذكسية التي تمارس التنصير في واحد من أضخم الأحياء القاهرية . مما سبق يجب أن ننتهي إلى عدة حقائق عامة ، ولكنها مهمة للغاية ، يسّرَت كثيراً على المنصرين تغلغلهم داخل ثنايا المجتمع ومحاولة تحقيق أدنى المكاسب ، وهي : أولاً: اضطراب العلاقات الأسرية بين الآباء والأمهات من ناحية ، وبينها وبين أولادها من ناحية أخرى . ثانياً: اضطراب العلاقات الدعوية بين الشيوخ والدعاة بعضهم البعض من ناحية ، وبينهم وبين الشباب من ناحية أخرى . ثالثاً: اضطراب العلاقات الإدارية والشرعية بين قادة المؤسسات الدينية بعضهم البعض من ناحية ، وبينهم وبين موظفيهم والدعاة العاملين تحت سلطانهم من ناحية أخرى . رابعاً: اضطراب العلاقات بين علماء ودعاة المؤسسات الدينية الرسمية وبين علماء ودعاة المؤسسات في الدينية الأهلية ، وتبادل عدم الثقة العلمية والإنسانية بينهما . خامساً: اضطراب العلاقة بين العلماء والدعاة وبين الشباب عموماً ، فتعددت المدارس الشخصانية ، وتبعها تعدد انتماءات الشباب ، وليس إلى اليمين أو اليسار أو الوسط ، إنما للشيخ فلان أو للشيخ فلان . سادساً: اضطراب العلاقة بين الشباب الملتزم والشباب غير الملتزم ، على درجة شبه فئوية أو طائفية مخيفة ، فاستعلى الملتزم بدينة على غير الملتزم ، ونبذ الشباب غير الملتزم الشباب الملتزم بتهمة الانغلاق والتشدد والتعصب ، مستجيباً للنظرة الإعلامية العدائية للالتزام . سابعاً: اضطراب العلاقة بين الشباب الملتزم وبين المدارس الدعوية التي تتنازعه ، بل واضطراب العلاقة الفردية مع النمط العقدي الذي ينتمي إليه الشباب . ثامناً: لعبت أجهزة الأمن الدور الكبير في تفكيك العلاقات العقدية والمدرسية والإنسانية بين الشيوخ والدعاة بصفة عامة ، وبتغذية روح التفكك التي ترسبت في الأنفس نكات سوداء أوغرت الصدور حتى باتت أمراضاً مستعصية العلاج على المدى القريب ، إن لم تتصاعد أكثر وتتعمق أكثر مع استمرار إهمالها ، لعل أوضح مظاهرها غياب إفشاء السلام بين الملتزمين في الشوارع والطرقات والمصالح العامة ووسائل المواصلات ، بل وحتى في قاعات العلم وداخل المساجد وفي ساحاتها . تاسعاً: بسبب القهر المتواصل ، تأصلت لدى الشباب الملتزم مشاعر الاستجابة الذاتية لقبول أي ممارسات عدائيه ضده من أجهزة الأمن وكأنها أصل من أصول الإيمان ، بسبب ما تكرس في النفوس أن جميع إدارات الدولة هي معادية للمسلم الملتزم ، وأنه لا توجد إدارة واحدة تقبل من المسلم شكواه في حق من يظلمه أو يعتدي عليه من الشرطة أو يعتقله بدون تهمة أو جريرة ، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان . عاشراً: اضطراب العلاقة بين القضاء ووزارة الداخلية ، إما سلباً بتواطؤ بعض الإدارات لدى الطرفين في الكيد للمتهم والانتقام منه ، أو إيجاباً بإصدار أحكام قضائية عادلة لا تلتزم بها إدارات الأمن أو تتحايل عليها ، مما أثر كثيراً على هيبة القضاء أو الثقة في عدله أو قدرته على الحكم وحماية تطبيقه . هذه العشرة أمراض ، تنقلنا إلى رؤية شاملة في مسالة الصراع الذي تتبناه الكنيسة ضد المسلمين على المستوى الشعبي والعملي ، مثدثرة ببعض المظاهر الكاذبة التي تحمل عناوين المحبة والحوار على المستوى الرسمي ، وهو الأمر الذي زاد الشقة بين المؤسسة الدينية الإسلامية التي تتمسك بجدوى الحوار في فنادق الخمس نجوم والمكافآت الدولارية التي تبعث على الدفء والاطمئنان النفسي ، وبين عموم المسلمين الذين يشهدون العبث المستمر للكنيسة وتحديها السافر لمشاعرهم والتعدي على عقيدتهم ، بالمنشورات والنشرات والكتب والمؤتمرات والندوات التي تمارس التنصير بصورة مباشرة أو غير مباشرة من ضلال برامج تحديد النسل وحقوق المرأة ومحاربة الختان (خفاض البنات) ودعم الحريات المنافية لقيم وأخلاقيات وثوابت الإسلام . ففي الوقت الذي لا يجرؤ فيه عالم أو شيخ أو داعية أو مسلم أو مسلمة أن يدعو مسيحي إلى الإسلام ، و في الوقت الذي لا نجد فيه كتاباً واحداً في المكتبة العربية يُعلم هذا النوع من الدعوة أو يحض عليه أو يضع له برنامجاً ، نجد على المحور الآخر ، الصراع الرهيب بين الطوائف الكنسية على توسيع رقعة نشاطها التنصيري في بلاد الإسلام عامة ، وفي مصر خاصة ، وتحت أيدينا من الوثائق العلمية والميزانية ما يصدق ذلك حتى لا يتهمنا واحد بالمبالغة ، بل تحت أيدينا فاتورة بيع للهيئة القبطية الإنجيلية لعدد من البهائم في أحد مشروعاتها الحيوانية وقد أطلقت على أسماء البهائم أسماء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم (عليّ وعثمان رضي الله عنهما) ، ورغم ذلك نجد أن هذه الهيئة هي التي تحتل مقدمة الداعين للحوار مع المسلمين ، وتظفر بالقبول والرضا من كبار المسئولين وصغار الإداريين المسلمين في المجالس المحلية وفي وزارة الأوقاف وفي الأزهر لفتح قنوات التنصير والهدم أمامهم ، لقاء فتات أموال يرمونها إليهم ، وأرجو ألا يحاول واحد من الأزهر أو الأوقاف أو في أي مجلس مدينة أن يكذب ما أقول ، فيمارس معي الرعونة في غير محلها ، لأن قوائم الدعاة المقهورين كلها مباحة لمن يريد الحصول عليها ، ولم تعد سراً من الأسرار ، للذين أجبرتهم إدارات الدعوة على التعامل مع القسس والرهبان في محاربة الإسلام ، والدعوة إلى ما لا يتفق مع ثوابتهم في قضايا تعدد الزوجات وحرية المرأة والمساواة وحقوق الإنسان في ممارسة الدعارة ومحاربة خفاض النساء والدعوة لتحديد نسل المسلمين وحرية الارتداد عن دين التوحيد . ولعل أنشطة كنيسة قصر الدوبارة بميدان التحرير ، والهيئة القبطية الانجيلية ، وجمعية الصعيد للتنمية البروتستانتية ، ومركز خدمات كنيسة شبرا الخيمة الأرثوذكسية ، ومنظمة كريتاس الكاثوليكية ، ومنظمة بلان انترناشيونال الصهيومسيحية ، وهم من قلاع التنصير في مصر ، قد فاحت رائحتهم إلى حد الزكم والقرف ، بما يمارسونه من جهود دءوبة في هذا المجال ، بلغت حد الجهر بالسوء ، ولجوء بناتهم إلى استخدام الجنس في تنصير شباب المسلمين وقريب من أيدينا حالتيّ زنا فتاتين إنجيليتين أولاد خالة مع شاب مسلم (م . ح) ، بمباركة الخالتين الشقيقتين ، انتهيا بتزويج الشاب من الفتاتين ثمناً لتنصيره رغم مخالفة ذلك للعقيدة المسيحية في كل طوائفها ، فتزوج الشاب الفتاة الأولى بمباركة أمها وخالتها ، ثم طلقها وتزوج الثانية وهي ابنة خالة الأولى بمباركة الخالة والأم ثم طلقها ، ثم طلق المسيحية والكنيسة وعاد ثانية إلى الإسلام عوداً حميداً ولا نزكيه على الله . ومن غير الملائم ألا نشير لأشهر في مصر ، مثل منظمة كريتاس الكاثوليكية ، وجمعية الصعيد الإنجيلية ، وجمعية نداء العلمانية ، وغيرهم عشرات من الكنائس والمنظمات الكنسية العاملة في مجال التنصير المباشر والميداني تعبث في شوارع وحواري وأزقة ومدارس الأمة المصرية من خلال وزارة الشئون الاجتماعية من ناحية ، والمجالس المحلية والشعبية من ناحية أخرى تحت شعارات التنمية وحقوق الإنسان والمرأة والطفل والسلام ، في الوقت الذي عقمت مصر بأبنائها المسلمين الذين يتجاوز عددهم (66) مليون نسمة من بين (70) مليون نسمة هم مجموع سكانها ، من أن تنشئ جمعية أو منظمة أو هيئة أو حتى دكان صغير لمواجهة هذه الحملة التنصيرية البشعة التي انتشرت كالنار في الهشيم في جميع محافظات مصر ، وتصلنا يومياً شكاوي وبكائيات من المسلمين الغيورين والخائفين على أبنائهم وبناتهم من مرسى مطروح والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والمنصورة وطنطا وسمنود وطلخا والزقازيق وبنها ، أما القاهرة فحدث بلا حرج ابتداء من عزبة الهجانة التي أصبحت أسطورة وانتهاءً بجامعة حلوان التي أصحبت وكراً للتنصير ، وبينهما تنتشر الكلاب السوداء المسعورة ، من شبرا الخيمة في شمال القاهرة حتى عزبة الوالدة جنوب حلوان ، أما مناطق المرج وأبو زعبل فمثلهما تماماً منطقتي المعادي الجديدة وطره والبساتين ، فالعمل التنصيري على قدم وساق وكأن القاهرة أصبحت كالمرأة (المومس) التي فتحت دارها لكل زان والعياذ بالله . وأنبه بشدة ألا يتهمني أحد بالمبالغة ، وإلا اتهمته بالجهل والجهالة والخزي والعار ، فالذي لا يعلم ، لا يجب أبداً أن يناقش فيما يجهله وأن يستر ماستره الله عليه من عدم الاهتمام بأمر المسلمين . والسؤال: هل نحن أضعف من مواجهة هذه الحملات وهذه الكلاب المسعورة ؟ الجواب: والله الذي لا إله إلا هو ، لو لم تقف أجهزة الأمن كحجر عثرة بيني (وأمثالي وأفضل مني مئات آخرين) وبين تثقيف أبناء مصر بما أهمله الأزهر والأوقاف عن قصد أو تقصير أو إهمال ، وتعريفهم بعقيدة الإسلام ، وبيان حقيقة دين المسيحيين ، وكتب المسيحيين التي يقدسونها ، والتثليث الذي يعتقدونه ، وصلبهم لربهم ، وتأليه رسولهم ، لما فلحت حالة تنصير واحدة في مصر كلها ، ولخرست جميع الكنائس التي تمارس التنصير في ربوع البلاد وأنحائها خلال شهر واحد من الزمان . لكن المشكلة التي لا نعرف لها حلاً ، هي سكوت أجهزة الأمن والتزامها الصمت ــ على ما نشاهده ونعاينه ــ تجاه الأنشطة الكنسية التنصيرية ، والاعتداء على عقيدة المسلمين وتسللهم إلى مؤسسات وبيوت المسلمين ، فإذا ما نهض واحد من دعاة المسلمين للدفاع عما يروجونه من أكاذيب وأضاليل وافتراءات ، لأوقفوه عن العمل ، ومنعوه من الخطابة ، وصادروا شرائطه ، واتهموه بإثارة الفتنة الطائفية ، ولم يكتفوا بذلك ، إنما يخوفون بقية الدعاة منه أو الاقتراب إليه . ونتعجب: لماذا هذا الميزان غير العادل ؟ لماذا لا تلجم الدولة كلاب الكنيسة ؟ لماذا لا تخرس الألسنة القبيحة ؟ لماذا لا تترك المسلمين يدافعون عن دينهم ؟ ونستغرب: إنه برغم ذلك الدور الذي تقوم به أجهزة الأمن لصالح الكنيسة وضد الإسلام ، فإن رعاع الكنيسة تركهم شنودة (ويملك توقيفهم) لينهشوا لحم رئيس الدولة ، ويسبوه ، وينهشوا لحم وزير الداخلية ، ويسبوه ، وأهانوا ضباط الداخلية بكل بذيء من الألفاظ القذرة التي يعف عنها اللسان ، وهو الأمر الذي يسبب حنقاً شديداً في الأوساط الفكرية والسياسية بل والدعوية التي غالباً لا يصيبها الحنق إلا عند افتقاد العلاوة السنوية في المرتبات الشهرية أو تأخير الترقيات . ولأجل ذلك ، فإننا ندعو المسلمين أن يعودوا إلى صوابهم ، ويستردوا عافيتهم ، ويجمعوا شتاتهم ، لممارسة حقوقهم في الدفاع عن عقيدتهم وفق الضوابط الشرعية التي لا تتوافر عند أصحاب ملّة غير ملّة المسلمين ، وأن يكاشفوا أجهزة الأمن بأعمال المسيحيين المدمرة للبلاد ، ويكتبون الشكاوى بذلك ، ويحررون المحاضر في أقسام الشرطة بكل اعتداءات المسيحيين ضد المسلمين ، وألا يتنازل مسلم في حقه أمام ضابط الشرطة ، ويطالب بتحويل الأحداث الإجرامية للمسيحيين إلى ساحة القضاء ، لتكون شاهداً على سوء أخلاقهم . كما أرجو من الفضلاء ضباط الشرطة ، ألا يمارسوا ضغوطهم على المسلمين لصالح المسيحيين ففي هذا ظلم كبير سوف يحاسبهم الله عليه ، حتى لو أقنعوا أنفسهم بأن في ذلك أمن البلاد وأمانها ، لأنه: إهدار للحقوق ، ودعم للظالم ، وإهانة للعدل ، وترسيخ للظلم . وأذكر حادثة شاهدتها بأم رأس في شارع (الجراج) بحدائق القبة في منتصف هذا الشهر (يونيو 2005) ، اعتدى فيها مجموعة من النصارى على محل بيع حلويات لأحد المسلمين ، فسبََّ المسيحي للمسلم الدين والعرض ، وخلع المسيحي جميع ملابسه ، وأخرج عورته من لباسه وأمسك بذكره وسط الشارع قائلاَ : أريد واحد من المسلمين أن يتصدى لي ؟ وأمسك شقيقه بعدة زجاجات خمر وقذف بها محل المسلم فهشم جميع زجاجه ، وعندما تدخل أهل الخير من المسلمين طلبوا من المسلم السماح والغفران والخوف من بهدلة الشرطة والأقسام ، وجاءت الشرطة وأخذت الطرفان ، وتحت التهديد والوعيد أو بالرضا والتسامح ( !! ) تنازل المسلم عن شكواه وتم الصلح بين الطرفين . وهذه صورة متكررة اليوم في كل أنحاء البلاد ، إما أن يرضخ المسلم لضوابط الأمن والسلام ، أو تشتعل الفتنة الطائفية التي تتخذ الشرطة لإخمادها قرارات القبض العشوائي والقصري على كل الأطراف ، وفي الليل يتم الاتصال الهاتفي من الكنيسة وتفرج الشرطة عن المتهمين المسيحيين قبل أن تعلم منظمات حقوق الإنسان في أمريكا وكندا وأوربا ، أما المسلمون فمن الممكن أن تفرج الشرطة عن بعضهم ، لكن ليس هناك ما يؤكد بقاء بعضهم الآخر لعدة شهور أو سنوات ، إذ على ما يبدو أنه كان عضواً في تنظيم الإخوان المسلمين أيام عبد الناصر ، أو مشتبهاً فيه أيام قضية قتل رفعت المحجوب قبل عشر سنوات . وأعود لأنهي مقالي بما حدث لابنتنا (زينب عصام) ، ومن خلال تجاربي وخبرتي وقراءاتي الخاصة في مجال التنصير ، أستطيع أن أستقرىء أسباب التنصير عموماً وأشكاله ووسائله باختصار شديد ، فأقول: أن المدخل الأول للتنصير هو معرفة مفاتيح شخصية المسلم ، من ثلاث نواح متوازية ؛ هي : 1ـ قوة الشخصية التي تتحدد من الرد الأول على اعتداء المُنَصِّر ، مدى القابلية للاستماع . 2ـ اكتشاف القدرة المعرفية للمسلم بإسلامه ، ليحدد موقفه من فتح باب الحوار أم لا . 3ـ تلمس أي معلومة شخصية حول الوضع العائلي لأسرة المسلم ومساحة استقرارها ، كمدخل نفسي أو عاطفي لكسب مساحة من قلب المسلم . وعلاج هذه المفاتيح الثلاثة : أ ـ ألا يسمح المسلم لنفسه بداية أن يسمع من المسيحي ما يخالف الإسلام من عقائد أو مفاهيم شركية ضالة ، (وسوف نبرر هذا الموقف الرافض بعد قليل) . ب ـ أن يغلق باب قبول أي كلام من المسيحي باعتباره تعدياً شخصياً على دين المسلم (وسوف نبرر هذا الموقف الرافض بعد قليل) . ج ـ لا يجب أن يتصور المسلم أن غلق باب الحوار مع المسيحي هو هزيمة شخصية ، لأن المُنَصِّر تم إعداده خصيصاً للقيام بتلك المهمة الشيطانية مع المسلم ، ويتقاضى المرتبات والمكافآت لقاء ذلك ، أما المسلم فلم يبذل دعاة المسلمين أدنى جهد لإعداده لمثل هذه المواجهة غير المتكافئة ، ولا يعيب العامي المسلم أو الطالب أو الموظف المسلم أن يفشل في إجابة سؤال من مسيحي مُنَصِّر ، لأنه ليس بالضرورة يعرف الإجابة ، ولأنه لم يَدّعِ لأحد أنه عالم أو شيخ ، بل ولا يعيب الشيخ أن يفشل في إجابة سؤال مسيحي ، لأنه لم يَدّعِ لأحد أنه متخصص في هذا الباع الذي تخصص فيه المُنَصِّر ، لكن العيب أن يظل المسلم العامي أو الطالب أو الموظف أو الشيخ بعد هذا الموقف ـ إن حدث له أو سمع عنه ـ أن يتهاون في سبر غور المسيحية ، ليعلم ويتعلم ألاعيب المسيحيين وكذبهم وافتراءاتهم وكيدهم للإسلام ، وأن كل ما يطرحونه على المسلم من افتراءات وضلالات ، لم تكن إلا بسبب جهله بإسلامه وقلة زاده من علوم الدين . د ـ للعقيدة المسيحية مفاتيحاً بسيطة للغاية ، لو يقف عليها المسلم لهدمها على رأس أصحابها ، لأنها عقيدة خاوية ، تحمل عناصر فسادها في داخلها ، ويكفيك فقط أن تسأل المسيحي عن كينونة ربه ليرتبك ويتفصد عرقاً ويعتذر لك عن استمرار الحوار ، وأنه مرتبط بموعد هام ، وأن أمه وأبيه وصاحبته وبنيه محجوزون في مستشفى الأمراض العقلية بسبب لفحة برد شديدة هبت من جنوب القاهرة محملة بالأتربة القادمة من جبل المقطم الذي قطمه القديس الأعور سمعان الأقرع في ليلة عاصفة ليس لها من دون الله كاشفة ، فعلى المسلم أن يتحلى بالثبات ، وأن يثق فيما هو عليه من الحق ، وألا تتزعزع قواعده الإيمانية بسبب جهله وجهل المسيحي الذي لا يعرف له رباً بسبب تعدد أربابه ، وتختلف طوائف المسيحية في تحديد يوم ميلاد كل رب من هذه الأرباب ، كما اختلفوا في تحديد نسب هذا الإله الرب ، أهو ابن يوسف أم ابن نفسه أم ابن أمه أم ابن زانية ولا حول ولا قوة إلا بالله . هـ ـ إن أحسن المسلم التعامل مع المُنَصِّر ، فقد أفسد على المسيحي خطته في استبيان المساحة المعرفية للمسلم (البند 2) ، ولن يتدخل المسيحي في حياته الشخصية (البند 3) ، فيتوقف الاعتداء عند أول خطوة (البند 1) ، ولكن من المهم للغاية إخبار الأسرة والأصدقاء وشيخ المسجد ، ليكونوا بمثابة مجلس شورى يساعد في دعم موقفه . و ـ إذا سقط المسلم في واحدة من الشراك الثلاثة (1 ، 2 ، 3) ولم يلتزم بالنصيحة في إخبار المقربين بما حدث (البند هـ) ، فيمكنه العودة بالانسحاب بشجاعة لعدم العلم ، وأنه لا يجوز أن يفتي في الدين من لا يعلم دينه ، ولا يضير المسلم أن يعجز عن إجابة سؤال لأنه ليس بعالم حتى لو كان السؤال كما صوره له المُنَصِّر تافهاً ، مما يستدرج المسلم لمحاولة إثبات ذاته والثأر لنفسه عن جهله ، فيغوص في وحل المُنَصِّر زيادة، مما يجعل الرجوع أكثر صعوبة ، ويكون مهماً أكثر من ذي قبل أن يصارح والديه وأصدقائه وشيخ المسجد لمعالجة الخطوة السابقة . ز ـ إذا فلح المُنَصِّر في استدراج المسلم إلى (البند 3) الذي يدعو للاستسلام له ، فيبقي له طوق نجاة واحد ، هو الاعتراف أمام نفسه بالفشل ، لكن عزاؤه الكبير أن المُنَصِّر تم إعداده إعداداً خاصاً ، وأنفق عليه آلاف الدولارات ليحقق هذا النصر مع هذا المسلم ، وليدرك المسلم أن سبب هزيمته راجع لأمرين : أولهما : يتحمله العلماء والشيوخ والعلمين والمنهج المدرسي الذي أهمل تعليم المسلمين . ثانيهما : إهمال المسلم تثقيف نفسه وانشغاله عن دينه وعن تحصيل الثوابت التي تجعل منه شخصاً قوياً قادراً على مواجهة هذا الاعتداء ، وهو أمر ليس صعباً ، ويستطيع المسلم في هذه المرحلة المتدنية من المواجهة مع المُنَصِّر أن يطلب الفرصة ليسأل أهل الذكر عن إجابة أسئلته ، ومن ثم ينتصر المسلم لنفسه بثلاثة أسلحة :
الأول: إخبار والديه وأسرته وشيخ المسجد حتى لو أساؤوا فهمه وتقدير موقفه ليشاركونه الأمر ، وإياك أيها المسلم أن تلتزم بوعدك للمُنَصِّر أو المُنَصِّرة الذي أو التي سوف يحذرك كثيراً من إ |